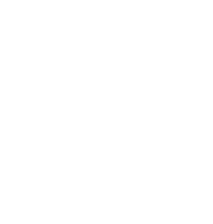بقلم: حمد عبيد المنصوري
ثمة سباق محموم بين المهارات والتقنيات، ونتائج هذا السباق هي التي تحدد ملامح المستقبل. وعلى امتداد هذا السباق ستختفي إلى الأبد مهن عرفناها، وستظهر أخرى لم نعرفها من قبل. وإزاء هذا المشهد سريع التحول تسري حالة من الخوف عند قطاعات واسعة من الناس تحسّباً لخسارة وظائفهم لصالح الروبوتات وأنظمة الذكاء والأتمتة على اختلافها.
وهذه الحالة ليست جديدة، فهنالك سوابق تاريخية عديدة خاف الناس فيها على أعمالهم نتيجة التطورات العلمية والتقنية، ففي بداية القرن التاسع عشر مثلاً، شهدت أوروبا طلائع وصول الكهرباء إلى المصانع، الأمر الذي أحدث تغييراً جوهرياً في وسائل الإنتاج، وقد شكّل ذلك صدمة لقطاعات معينة، ومن بينهم عمّال النسيج الذين رأوا في الأمر قطعاً لأرزاقهم ودفعاً لهم إلى رصيف البطالة. وبلغ اليأس حداً دفع العديد منهم إلى تحطيم الماكينات الكهربائية والخروج للشارع احتجاجاً، لكن الأمر لم يطل قبل أن يدرك أولئك العمال أن النقمة على ما هو جديد لا تحل المشكلة، وأن الحل يكمن في التعامل بذكاء مع المستجدات.
والتعامل بذكاء هنا له معنى واحد، هو التكيّف والمرونة. وهاتان المهارتان كانتا دوماً من عناصر النجاح، وهما اليوم تتصدران قائمة طويلة من المهارات «الناعمة» المطلوبة لخوض غمار الثورة الصناعية الرابعة وعصرها الذي يمتاز بتغيراته المتسارعة، وبمفاهيمه المتبدلة، وبتقنياته غير المسبوقة، كما في التحول الرقمي والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها.
المهارات الناعمة كانت مهمة دائماً، لكنها اليوم أكثر أهمية، وهي تضم عناوين عديدة، من بينها التواصل الاجتماعي، وحل المشكلات، والابتكار، والتفكير النقدي، وإدارة العلاقات، والتنسيق مع الآخرين، والذكاء العاطفي، والتفاوض.
والجدير بالذكر أن جل هذه المهارات تنشأ وتتطور في البداية في كنف الأسرة، وفي مرحلة مبكرة من الطفولة، أي قبل المدرسة. وعلى الرغم من الحضور القوي للأدوات التقنية والألعاب الرقمية في حياة الأطفال، فإن التدخل الذكي والإشراف الحثيث من جانب الأسرة يُكسب الطفل ملكات كالإحساس بالجماعة وسرعة التفكير والتعاون مع آخرين لحل المشكلات المعقدة، وغيرها من المهارات سالفة الذكر. وكل هذه لبنات أساسية لشخصية ناجحة تنتمي إلى هذا العصر.
ماذا يتبقى للمدرسة إذن؟
هذا السؤال في غاية الأهمية، وهو بالتأكيد مدار بحث ونقاش لدى خبراء التعليم ومسؤوليه، الذين يدركون أكثر من غيرهم أن الأمية لم تعد تعني عدم القدرة على الكتابة والقراءة، وإنما هي الأمية الرقمية والتقنية، لذا فإن أمام خبراء التعليم أسئلة جوهرية تتعلق بكيفية بناء الجيل الذي يجيد التعامل مع أدوات عصره، ويدرك معنى تحليل البيانات والمعطيات، ويفهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي، ولديه وعي عالٍ بمقتضيات الأمن السيبراني ووسائل الحماية والسلامة على الإنترنت، ويمتلك جرأة الاستزادة المعرفية عبر القنوات الرقمية المتاحة.
أما الحديث عن التعليم العالي (الجامعي) فهو حديث ذو شجون، فلا يجادل أحد حول أهمية الشهادة الجامعية، لكن صاحب العمل يتوقع من المتقدم للوظيفة أموراً أخرى تتعلق بالقيمة الفعلية التي سيضيفها إلى المؤسسة، لذا فإن الخريج الجامعي الذي يبحث عن مكان في سوق العمل عليه أن يكون متقناً مفاهيم عصره، وأن يكون قادراً على المنافسة في بيئة عمل جديدة كلياً؛ بيئة تتطلب قدراً عالياً من التفكير المبدع والابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
وهذه المتطلبات لا مساومة عليها في عالم اليوم، فالبشرية تخوض سباقاً للإمساك بدفة المستقبل. وفي سبيل ذلك يشهد العالم ما يسمّى بثورة المهارات. وقد أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي حملة دولية لإعادة «تمهير» مليار شخص بحلول 2030، هذا الرقم يمثل ثلث القوى العاملة في العالم، وهو الحد الأدنى المطلوب لسد الفجوة المهارية. وبخلاف ذلك فإن اقتصادات العالم ستخسر الكثير. وقد أشارت دراسة صادرة عن مؤسسة أكسنتشر إلى أن الدول العشرين الكبرى (G20) وحدها معرضة لخسارة ما يزيد على 11.5 تريليون دولار من ناتجها القومي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، ما لم تسارع إلى سد الفجوة المهارية. إن ثورة المهارات قائمة وتجري على قدم وساق بالتوازي مع التغيرات الجذرية في كل مناحي حياتنا. والمطلوب هو العمل على تأطيرها في سياق استراتيجي وشمولي يبدأ من الأسرة، ويمر عبر المدرسة، وصولاً إلى الجامعة، ثم بيئة العمل نفسها. بهذا نضمن الانتقال من الريادة إلى المزيد من الريادة بإذن الله.